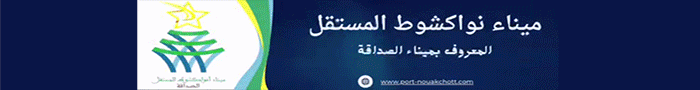في كل مرة تُكشف فيها فضيحة لأحد من يُنسبون إلى الصلاح، يتسابق بعض المتربصين إلى استخدام الحدث كأداة لهدم المنظومة الأخلاقية بأكملها، والتشكيك في كل من يظهر التدين أو يحمل ملامح الدعوة. ولا يقف الأمر عند حدود النقد، بل يتحول إلى غزوٍ فكري ناعم، يُراد منه زرع الشك في كل قدوة، وخلق صورة نمطية سوداء تقول: “أهل الحايا خطيرين”، “وهذو الدعاة خطيرين”، وكأن كل من تمثّل الدين صار موضع تهمة حتى يثبت العكس.
وهذا خلط خطير، يتناسى أن أكثر الجرائم الكبرى في التاريخ المعاصر – من فساد، ونهب، وتهريب، وقتل، وترويج للفاحشة – ارتكبها أناس لا علاقة لهم لا بلحية، ولا بخطبة جمعة، ولا بأي مظهر ديني. فلماذا لا نسمع أحدًا يقول: “الناس ألي بلا لحايا خطيرة”، أو “كل حد لابس فست خطير”؟!
ولو سرق شخص من قبيلة معينة، لا أحد يقول: “أهل هذه القبيلة خطيرين”، فكيف نقبل بهذا المنطق الظالم حين يكون المستهدف صاحب لحية أو إمامًا أو داعية؟
والأدهى من ذلك، أن الجريمة حين تقع، تسقط كل وصف سابق لا يتوافق معها. فالمتلبس بتهريب المخدرات أو الفساد، لا يصح أن نخاطبه بـ”المتدين” أو “الشيخ” أو “الإمام”، بل هو مجرم، تُخاطبه صفته الحقيقية، تمامًا كما تُنزع رتبة “الضابط” عن العسكري الخائن، ويُعامل كمجرم لا كممثل للمؤسسة الأمنية.
من الناحية المنطقية، لا يمكننا أن نُبقي على وصف “الداعية” أو “المصلح” لمن خان أمانة الدعوة، ولا أن نستمر في نسبته إلى التدين وهو ينقضه بأفعاله. فإن كنا لا نعمم الحكم على قبيلته، أو مهنته، أو مجتمعه، فلا يجوز أن نعمم أيضًا الحكم على الدين، أو على كل من يُظهر الالتزام به.
نحن هنا لا نناصر كل منافق أظهر الدين وأبطن خلافه، بل ندين فعله أشد الإدانة، ونستنكر أن تُتخذ مظاهر الصلاح غطاءً للفساد.
لكننا أيضًا لا نسمح بأن يُستخدم هذا الانحراف الفردي كمعول لهدم القيم، ولا أن تُهدم القدوات لأن بعضًا ممن تشبّهوا بها خانوا.
علينا أن نمتلك من الوعي ما يُمكّننا من فصل جوهر الإنسان وأفعاله عن ما يتمثله من رموز أو شعارات.
فلا لحية تعني صلاحًا بالضرورة، ولا غيابها يعني انحرافًا، ولا منصبًا يزكّي أحدًا، ولا لباسًا يبرئ صاحبه.
المعيار الحق هو الفعل، والسلوك، والصدق في الالتزام، لا المظهر ولا العنوان
الذهبة